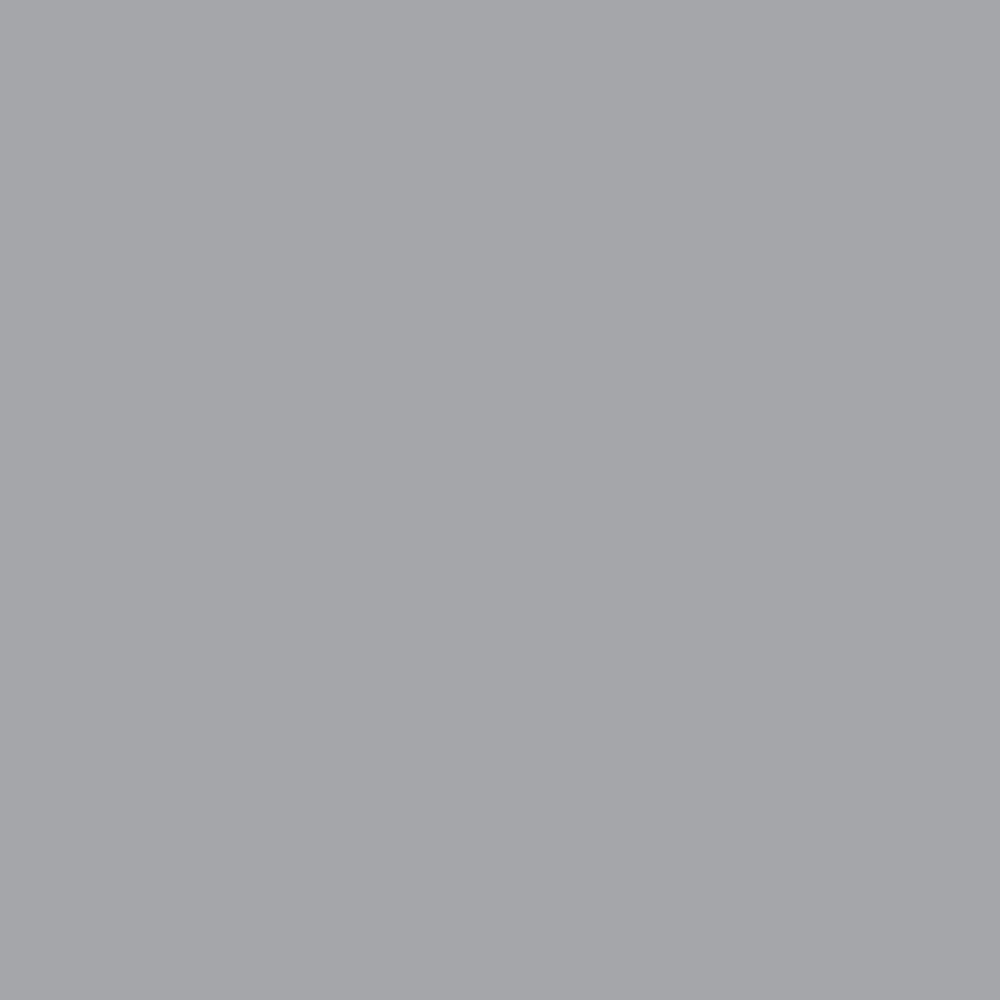لطالما استعصت العربية الكلاسيكية الفصحى، بعمقها الساحر ورنينها الأخّاذ، على الترجمة الكاملة. يقف اللغويون والعلماء أمام مفرداتها وقوف المأخوذ، إذ تتدفق بمعانٍ متراكبة، وتنبض بجمال يتجاوز حدود الألفاظ ليبلغ أعماق الروح والوعي. في عصر الجاهلية — تلك الحقبة المديدة التي سبقت بزوغ فجر الإسلام بمئة وثلاثين عامًا — كانت العقول وقّادة، والفطرة قادرة على اقتناص الحكمة من لمحة عابرة، واستخلاص المعنى من جريان الحياة. لم يكن الشعر آنذاك مجرد قول منظوم؛ بل كان مرآة للروح، وسجلًا للقيم، ونشيدًا للهوية. تمازجت فيه أغراض الهجاء والمدح والفخر والرثاء والغزل والوصف والحكمة، فنسجت نسيجًا ثقافيًا سبق الوحي.
وفي قلب هذا التراث الضارب في القدم، يتربع الشعر الجاهلي لا كفن فحسب، بل ككائن حي ينبض بروح العرب، يحفظ أصداء الذكريات الضائعة، ويعكس عاداتهم ومعتقداتهم، ويغرس وعيًا ثقافيًا يتجاوز حدود الزمن. كان الشعر عندهم ضرورة وجودية، لا ترفًا، فهو الذي يخلّد المشاعر، ويوثق البطولات، ويشعل الحنين، ويهذب الذائقة. كثيرة هي الحكايات التي تناقلتها الشعوب، لكن قصة قيس بن الملوح وليلى تظل الأشد سحرًا، والأبقى أثرًا. فهي نموذج متوهج للإخلاص، وحب يتجاوز الرغبات المادية، لم تدنسه الشهوة ولا شابته مطامع الدنيا. ظل هذا الحب في الذاكرة رمزًا للبراءة والتوق الروحي، يرن صداه عبر الأجيال بوصفه “أنقى تجلٍّ لحنين القلب البشري إلى التحرر من أسر الرغبة وابتذال الهوى”. فماذا يعني ذلك؟
في زمن كان الحب فيه قدَرًا والكلمة سلطانًا، عاش قيس، شاعر العشق الطاهر، في براري نجد. نشأ مع ابنة عمه ليلى، يلهوان في طفولة بريئة بين قطعان الغنم تحت شمس الصحراء، تتلاقى أرواحهما كما يلتقي النسيم بالرمال. لكن أعراف البادية كانت صارمة؛ فما إن بلغت ليلى سن الحجاب حتى بدأت رحلة الفراق. تقدم قيس لخطبتها، لكن القبيلة أبت إلا أن تلتزم تقاليدها، ورفض الأهل عرضه خوفًا من العار بعد أن شاع حبهما. لم يكن الرفض متبادلًا، بل كان صراعًا بين العائلتين، وخشية ليلى من الفضيحة.
تجرع قيس مرارة الفراق، فهام في الصحارى، يؤانس الوحوش، وينشد الأشعار التي صارت منارة للعشاق من بعده. رأى ظل ليلى في كل نسمة، وهمسها في كل ريح، حتى عُثر عليه يومًا ميتًا، وأصابعه تكتب آخر أبيات العشق والحنين:
وضع رأسه على حجارة الفلاة والوهاد
ومات، وقلبه جريح، وصدره مختوم بالأحزان
يا ليت هذا المحبوب أحب مرة واحدة
ليدرك ما يقاسيه المهجور في النوى
ديوان قيس: منارة العشق العربي
ومن روائع ديوانه التي لا تنسى ليلى: وأيضًا: وأيضًا: وفي النهاية، رحل قيس عام 688م، وُجد جسده بين الحجارة، وآخر أبياته منقوشة بجانبه — شهادة على حب جعل من الألم شعرًا، ومن الشوق معنىً خالدًا لا يموت.
تحوّل ديوان قيس إلى منارة في سماء الغزل العربي، تجاوز أثره حدود الجزيرة ليطبع الأدب الفارسي وغيره. لم تكن أشعاره مجرد كلمات، بل صرخة وجود، وتوق إلى المستحيل، ورمز للوفاء الذي لم تكسره قسوة الأعراف. في قصته تتجلى فلسفة الحب الإنساني في أصفى صوره: شغف لا يبتغي جزاء، وإخلاص لا تهزّه المسافات، وحنين يبقى حيًا بعد أن يفنى الجسد.
ظل قيس بن الملوح في الوعي الجمعي العربي أيقونة للحنين الوجودي: قلبه القلق “حوّل الألم إلى شعر”، وصارت المسافة شعورًا مقيمًا، وغدا الحب أسطورة خالدة تتجاوز حدود الفناء.
أذكر ليلى والسنين الخواليا
وأيام لا أعد الليالي
أعد الليالي ليلةً بعد ليلة
وقد كنت لا أعد الليالي
أحبك يا ليلى وأنتِ صغيرة
وأنا ابن سبع لم أكمل الثماني
يقولون ليلى بالعراق مريضة
فيا ليتني كنت الطبيب المداويا
يقولون ليلى سوداء حبشية
ولو لا سواد المسك ما انباع غاليا
بلّغوها إذا أتيتم حماها
أنني مت في الغرام فداها
واذكروني لها بكل جميل
فعسى ذكرها يهيج شجاها
واسألوا قبرها الشريف عني
فعظامي تذوب شوقًا إليها
إن روحي ترف حول ثراها
وعيوني تذوب شوقًا إليها
ولئن طال في القيامة وقوفي
فلأجل الرجاء أن ألقاها