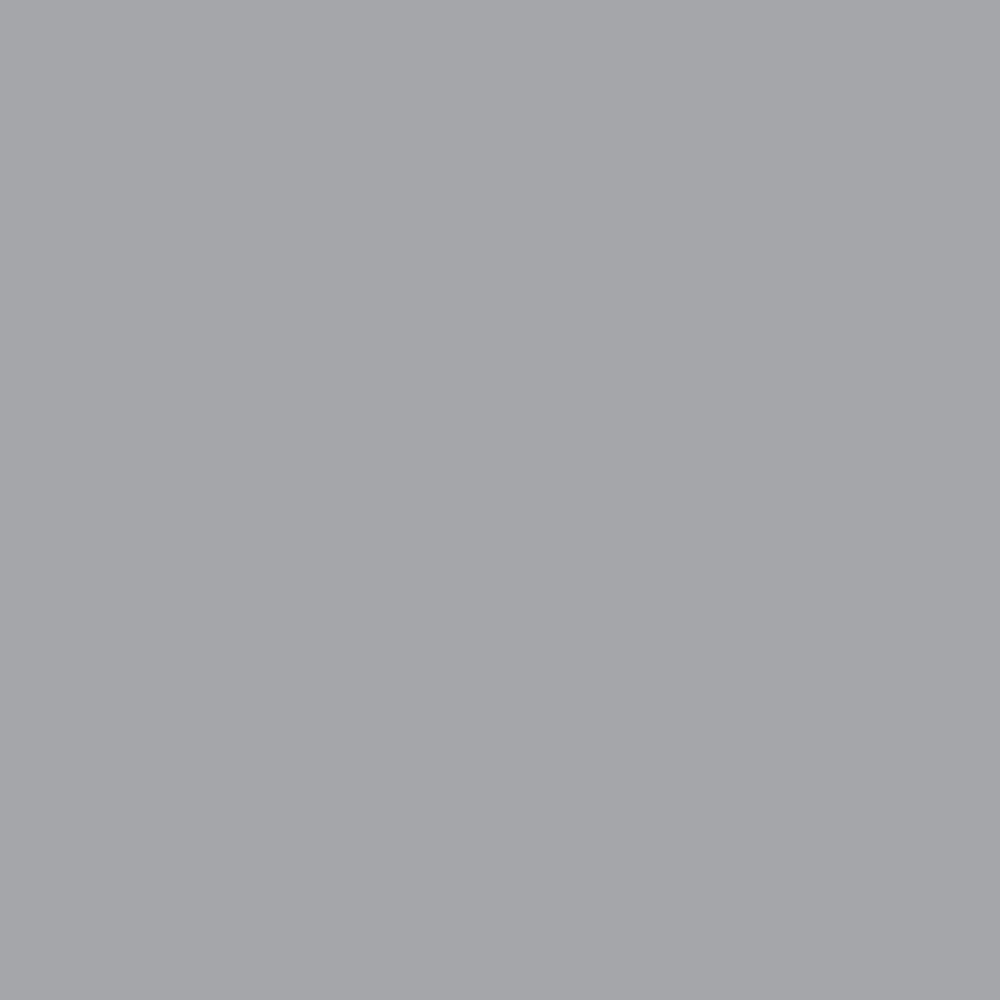ثمّة أقدار نختارها نحن، ووأقدار أخرى تختارنا.
الصحافة، بالنسبة لي، لم تكن يومًا جزءًا من خطة مستقبلية، لكنها استدت جتني في أشد مصائدها خفاءً: سطور قليلة كتبتها على عجل بينما كنت أنتظر مقابلة. أربعمئة كلمة عابرة، لم أُرد بها سوى إضاعة الوقت، فإذا بها المفتاح الذي فتح بابًا لم أكن أعلم بوجوده أصلًا. بالنسبة لرئيس التحرير، كانت تلك السطور بشير صوت قادم؛ أما بالنسبة لي، فكانت مجرد تمرين عابر. وهكذا يعمل القدر غالبًا: لحظاتنا الصغيرة ترتدّ أصداؤها أوسع من أكثر نوايانا تعمّدًا.
في تلك السنوات الأولى، دخلت قاعة التحرير كما يدخل المرء إلى أتون.
كل مقالة كانت تُصاغ وتُعاد صياغتها، تُجادل وتُختبر، حتى تصمد أمام نار النقد العام. صار المصححون فلاسفة في شؤون علامات الترقيم، والمحررون فرسانًا في دروب الدلالات، ورئيس التحرير حارسًا متوجسًا من الانفجارات الكامنة في العناوين. لم نكن نخشَى خطأً إملائيًا بقدر خشيتنا سوء التأويل، ولا انزلاقًا نحويًا بقدر ما نهاب غضب السلطة. اكتشفت حينها أن الكلمات معادن متفجرة؛ إن أُخذت باستخفاف، انفجرت.
ثم جاء التحول.
تركت جدّية السياسة الخارجية لصخب المسرحيات الساخرة. حلّت القهقهة مكان الرصانة، وصارت السخرية أداتي. أن تكتب كوميديا هو أن تُحدث ثغرة في جدار الثقل، أن تكشف حتى أن السياسة ذاتها تختبئ خلف قناع هزلي. تحوّلت من حيث لم أخطّط إلى مبارز في ساحة الفكاهة، أخوض معارك نصوص مع استاذي حاج محفوظ، أحد كبار الكتّاب في المنطقة. هذه المرة لم يأتِ القرّاء بردود غاضبة بل برسائل تبعث الدفء، رسائل عبر البريد تحمل رائحة الرحلات والطوابع.
ثم وُلد تجسيد آخر: الصحافة الرياضية.
إيقاع مختلف، جمهور آخر، لكن النبض الخفي ذاته كان يجذب الناس إلى الحكاية. كأن نهر الكتابة قادر أن يتفرع إلى أي مجرى، شرط أن يثق الكاتب بالمسار. ومع ذلك، وبالرغم من الشهرة أو الطرافة أو الإقبال، لم أعتبر نفسي يومًا إلا مراسلًا. الصفحة الأولى كانت ضميري، والوقائع إيماني، وكل ما عداها مجرد أداء.
غير أن المهن، مثل الأجساد، تتعب.
وجاء اليوم الذي وضعت فيه القلم جانبًا، متعمدًا إدارة ظهري لسيل الأخبار. سنوات من الصمت مرّت. وحين عدت إلى الكتابة، وجدت أن السحر قد تلاشى؛ ذهبت خفة السرد وبريق النكتة، ولم يبقَ سوى حدس صلد، يقظ، لا يموت: غريزة التحليل، القدرة على رؤية هندسة القوة المستترة داخل كل حدث. فالتحليل، على عكس الأسلوب، لا يذوي؛ بل يتصلّب كالعظم.
ومع ذلك، فالزمن يأخذ حصّته.
عمرٌ من المواعيد النهائية والسجالات والنزاعات يترك أثره على الجسد، فيحمل المرء ندوبًا وأمراضًا كما يحمل الذكريات. ومع ذلك، لا أستطيع أن أسميها حياة مهدورة. أن تكون صحفيًا هو أن تصارع الواقع في أقسى أشكاله، وأن تخاطر بنفسك في رهان هشّ حول إمكانية قول الحقيقة من الأساس.
ربما فقدتُ بريق الأسلوب، لكن عادة التساؤل ما تزال.
وهذا هو مفارقة الرحلة الأخيرة: حتى حين يضعف الصوت، يبقى الإصغاء يقظًا. فالكلمات لا تغادرنا ببساطة؛ إنها تصوغنا، تطاردنا، وتحفظنا في مرآتها. وما تعلمته بين كل تلك التحولات — السياسة، السخرية، الرياضة، الصمت — أن القلم لا يسجل الحياة فحسب، بل يبتكر الشخص الذي يمسكه.
الصمت بين الفكر والآلة
نعيش اليوم لحظة عتبة في التاريخ: طلوع عصر الذكاء الاصطناعي، حيث غدت أسماء مثل ChatGPT وDeepSeek شبه مألوفة في البيوت، تعد بمساعدات فورية في مهام كانت تتطلب ساعات طويلة من الكدّ.
طقوس الكتّاب القدامى – تقليب القواميس ومناغاة المترادفات، الإنصات للجملة بصوت عالٍ حتى تُرضي الأذن، أو صراع الفقرة حتى تزن الفكرة بحق – تتلاشى شيئًا فشيئًا. ما كان يستلزم الصبر الحَثيث والمعاناة الحميمة بات اليوم يُلمَّع في لحظات.
ومع هذا التطور الصامت، وربما الثورة، يكمن تناقض دقيق.
الآلات قادرة أن تصقل وضوحنا، أن تهذب بلاغتنا، أن تمنح نصوصنا أناقة سطحية.
لكنها لن تبتكر ما يعتمل في دواخلنا قبل أن يتجسد. منشأ الفكرة – ذلك الهمس الرخو، غير المصقول، في وعي الإنسان – يبقى عصيًّا على الاختزال، متشبثًا بإنسانيته الخالصة.
الفيلسوف مارتن هايدغر حذر في تأملاته حول التقنية من “الإطار الجامع” – نزعة الأدوات إلى إعادة تشكيل إدراكنا للعالم، ضاغطةً إياه في ما هو محسوب، مكرر، نافع.
حتى اللغة يمكن أن تقع أسيرة هذا التضييق، لتصبح مجرد ناقل معلومات بدل أن تظل بيت الوجود ذاته. وفي هذا السياق، لا يحرر الذكاء الاصطناعي اللغة بقدر ما يهدد بتسطيحها، بجعلها كفؤة، موحدة، آمنة. وما يضيع في الطريق هو رعشة التردد، وجمال التلكؤ، وفصاحة اللحظة المربكة.
أما مارشال ماكلوهان فذكّرنا أن “الوسيط هو الرسالة”.
الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مساعد في الكتابة، بل وسيط جديد للفكر، يعيد تشكيل طرق بناء الأفكار نفسها. فإذا كان القلم والورق يستدعيان البطء، بتلك الألفة الحميمة بين اليد والفكر، فإن الكتابة مع الآلة تُسحرنا بالسرعة والانسياب. خطرنا ليس أن تفكر الآلة بالنيابة عنا، بل أن نتوقف نحن عن تعلم فن التفكير المتأني بأنفسنا.
ومع ذلك، فإن في حضوره هبة متناقضة: بمواجهتنا آلة تعكس ولا تبتكر، نتذكر سر عقولنا.
فعل الإبداع البشري يبدأ في الصمت – في فوضى الهمسات التي لم تصغ بعد إلى لغة. لا خوارزمية تستطيع اقتحام هذا البرّ الداخلي الموحش. الآلة ترتّب، لكنها لا تحلم. تحسب، لكنها لا تحزن. تردد، لكنها لا تتعجب.
عصر الذكاء الاصطناعي أقل صراعًا مع الإحلال وأكثر مرآة للإنسان.
إنه يرغمنا أن نسأل: ما الذي لا يمكن استنساخه؟ لعلها ليست أناقة جملة ولا براعة برهان، بل ذلك الصراع المربك وراءهما – هشاشة المحاولة والخطأ، سعي يائس إلى ما وراء المعروف. هذا هو ما يجعل الفكر حيًا
فهُم النزال مع المرآة والجملة قد يتلاشى، لكن ما يبقى عصيًّا على الآلة هو الفعل الداخلي – المتناقض، غير المكتمل، الإنساني.
الذكاء الاصطناعي يرقمن السطح؛ أما الأعماق فهي ما يزال علينا كشفها بأنفسنا. التحدي ليس أن نصبح زوائد لماكيناتنا، بل أن نتمسك، بإصرار أعظم، بما لا يُؤتمت فينا: شجاعة التفكير، والقدرة على الشعور، والجرأة على الكلام بأصواتنا الفريدة.