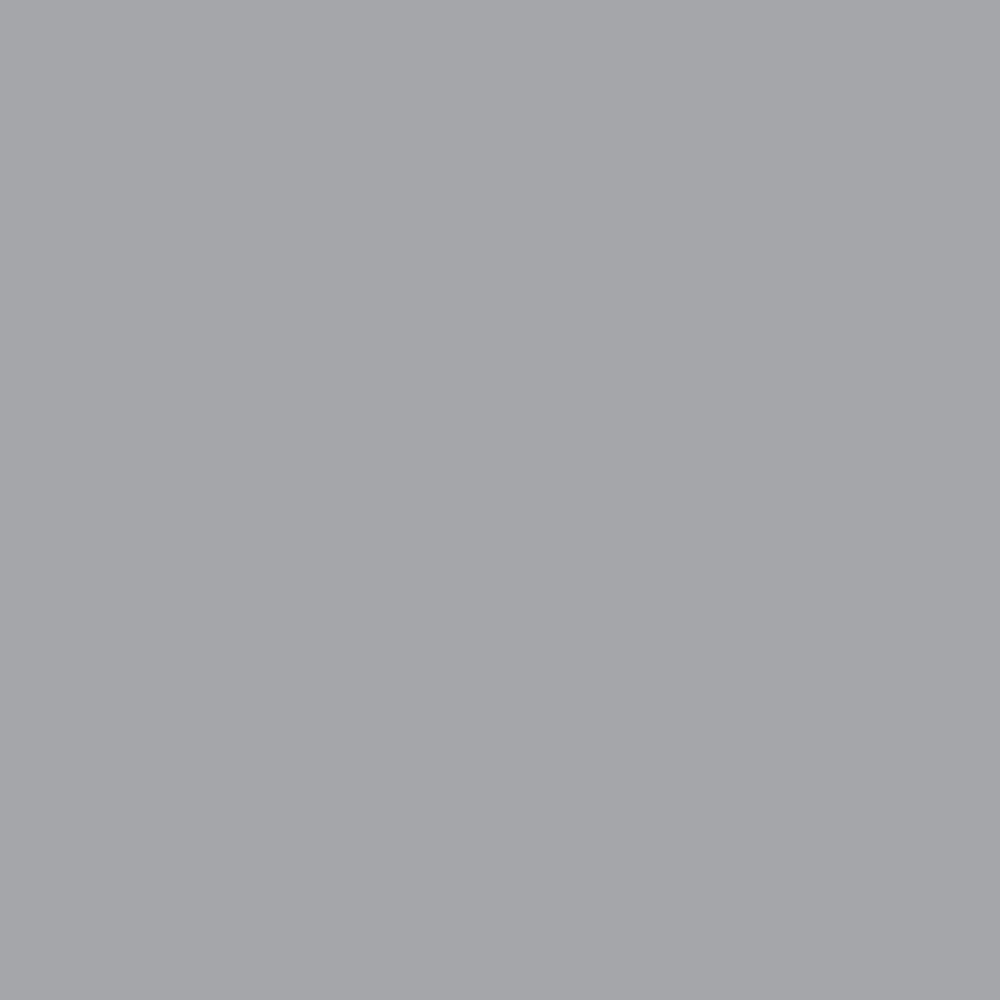نشر الكوميدي ديفيد باديل ذات مرة صورة مثيرة للتأمل على منصة تويتر: صورة رسم كارتوني يمثل شرير، سرعان ما يسارع كثيرون إلى وصفه بـ”القبيح” أو رسم ملامح الشر على وجهه، ودونما إمعان أو وعي بما يدفعهم إلى ذلك. وانطلق يتساءل: لماذا ترى أعيننا هذا الإنسان قبيحاً أو
شريراً فقط لأن ملامحه لا توافق أذواقنا؟
إن هذا التساؤل يمسُّ جوهر الحقيقة الإنسانية القديمة: لطالما قيل إن الجمال يكمن في عين الناظر. إنه انعكاس متحوّل للذائقة الشخصية، تصقله تجاربنا وثقافاتنا ومشاعرنا. فما يسرق أنفاس أحدنا قد لا يثير شيئاً في الآخر. فالجمال ليس مجرد تناسق أو إشراق، بل هو تلك اللمسة الغامضة التي توقظ في أعماقنا الذهول، قد يكون في مشهد طبيعي، أو لحن شجي، أو حتى في دفء ابتسامة عابرة.
ورغم هذا الطابع الشخصي المتفرد، طالما سعت المجتمعات لتأطير الجمال في قوالب محددة، سواء عبر مسابقات ملكات الجمال أو الإعلانات التجارية أو منصات التواصل الاجتماعي. في محاولة لتقنين ما لا يقبل التقنين، وتحويل الانطباعات الذاتية إلى معايير موضوعية. لكن، إذا صار الجمال يقاس كدرجات على ورقة تقييم، فهل يبقى ملكية فردية؟ إن هذه المعايير قد تصوغ الذائقة الجمعية، لكنها عاجزة دوماً عن الإحاطة بعُمق التجربة الجمالية وفرادتها في قلب كل منا.
وعلى الطرف المقابل من هذا التوازن الرفيع، يقف القبح - كثيراً ما يُرفض أو يُدان، لكنه لا يقل كشفاً لأسرار المجتمع. فتصوراتنا حول القبح تكشف عن قيمنا، وانحيازاتنا، بل وحتى جذورنا النفسية والغريزية. فالقبح ليس غياب الحسن فحسب، بل قد يجسد الوصم، والإقصاء، ومحورية “الآخر”، تأثراً بأعراف المجتمع أو تحاملاته اللاواعية، أو حتى صدى لنزعات قديمة نشأت مع الإنسان.
إن الحكم على شخص بالقبح غالباً لا يرجع إلى صفات ملموسة بقدر ما يرتبط بتوقعات ثقافية أو تصورات مغروسة في وعينا. وهذا التأثر السريع يلامس جوهر الإنصاف والكرامة والتعاطف الإنساني. وعندما نتأمل أسباب نفورنا من ملامح أو أشكال معينة، نكتشف عُمق البنى الخفية لمجتمع يربط الحسن بالصلاح أو الجدارة.
في نهاية المطاف، فإن مراجعة مفاهيمنا عن الجمال والقبح دعوة لتبني رؤية أكثر شمولاً لتعقيدات النفس البشرية، وانفتاح أوسع على التعاطف وتهذيب الأحكام، والإدراك بأن لكل وجه حكاية، ولا توجد حكاية أحق بالاحترام من أخرى.
الجمال والقبح: الإدراك، الأحكام المُسبقة وقوة المنظور